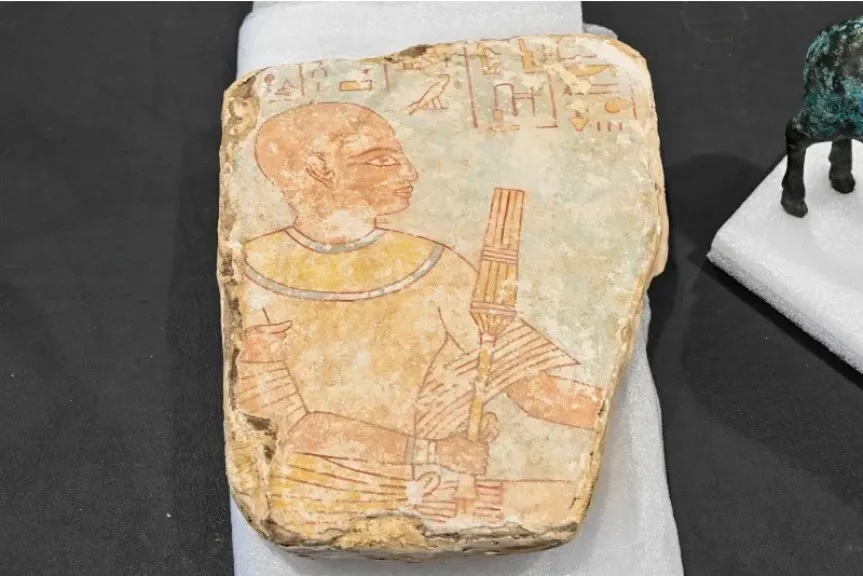لم تعرف القصيدة العربية – على مدار عصورها المتعاقبة وعلى عكس ما هو شائع – فكرة الثبات، فقد ظلت محاولات التجديد والمغايرة، منذ أن تمرد زهير بن أبي سلمى قائلًا: ما أرانا نقول إلا مُعارًا أو معادًا من قولنا مكرورا، ومنذ أن تساءل عنترة في أسى: هل غادر الشعراء من متردم، أو قول أبي العتاهية: "أنا أكبر من العَروض"، أو سخرية المتنبي من أغراض الشعر بقوله: إذا كان شعر فالنسيب المقدم / أكل فصيح قال شعرًا متيم. ومع العصر الحديث تعاقبت المدارس الشعرية من الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة مرورًا بالرومانسية بأجنحتها المختلفة (الديوان – المهجر – أبوللو) وقصيدة التفعيلة أو ما شاعت تسميته بالشعر الحر، وأخيرًا قصيدة النثر. وقد أصبح التجديد مرتبطًا بملمحيْن أساسييْن هما التجديد الشكلي في اللغة وبناء الصورة الشعرية والموسيقى، وتغير مفهوم الشعر والشاعر، وهو أساس المغايرة الشكلية.
شهد مفهوم الشعر والشاعر مجموعة من التغيرات الجوهرية ، فقد كان الشاعر قديمًا وحتى القصيدة الكلاسيكية الإحيائية شبيهًا بزرقاء اليمامة التي ترى أبعد من غيرها وتحذر قومها من الهلاك وتنصحهم بما تراه، وكان الشعر مرآة عصره، حيث يعكس آمال وآلام أمته؛ على نحو ما يبدو في قول شوقي: كان شعري الغناء في فرح الشرق / وكان العزاء في أحزانه. ثم بدأ مفهوم الشاعر النبي مع القصيدة الرومانسية مصداقًا لقول علي محمود طه واصفًا الشاعر بقوله: نزل الأرض كالشعاع السني / بعصا ساحر وقلب نبي. ومع قصيدة التفعيلة أصبحنا أمام ما يمكن تسميته بتعبيرات جرامشي، المثقف العضوي الطليعي الذي يبشر بالمستقبل، ثم حدث انكسار هذا النموذج مع شيوع قصيدة النثر، فأصبح الشاعر شخصًا مهمشًا مغتربًا لا يستشعر أي تمايز بينه وبين الآخرين، وهذا ما نراه في ديوان "أكلم الأبواب" للشاعر نادي حافظ، فالشاعر يصحو أحيانًا كثيرة فلا يجد قدميه مما يدل على عجزه عن السعي والحركة والتقدم، فيتحول قلبه إلى "تفاحة عطنة"، ولا يكون أمامه إلا محاولة الهروب من زنزانته حتى لو مشى "على قدم واحدة" متحولا إلى طفل يحبو. وفي السياق نفسه يقول شحاتة إبراهيم تحت عنوان "الشاعر": "الشاعر ليس إلها صغيرًا / ليفني عمره كله في الاستعارة والمجازات / لكنه يعود اليوم إلى الشوارع / باحثًا عن الجوعى والمرضى والمشردين / ليربت على أكتافهم / في حنان بالغ / وليبكي معهم ساعة على أقدارهم التعيسة". فالشاعر لا يمتلك – بداهة – قدرة إله على تغيير العالم، إن موطنه الأساسي هو الشوارع التي يقطنها الجوعى والمرضى والمشردون، الذين ينتمي إليهم بوصفه واحدًا منهم باكيًا على أقدارهم التعيسة. وامتدادا لهذا نجد صبري رضوان يعبر عن حبه للشعر وتعلقه به بغض النظر عن موقف الآخرين من هذا الشعر، فالشاعر مكتف بنفسه وببوحه، على نحو مايبدو من قوله: "هذه قصيدة وأنا شاعر / وأنتم مضطرون – طبعا- إلى سماع قصيدتي هذه / لذلك سوف أجعلها مهذبة جدا / وطبيعية جدا/ وسوف أستميلها وأدللها / تارة أقدم لها القهوة وتارة أمتدحها". إن الشاعر – كما يصرح في موقع آخر- ليس مثل الشعراء الكلاسيكيين الذين يسعون إلى استمالة المتلقين باللغة البيانية والإيقاع المنتظم، يقول: "أنا لا أشبه أحدا / لا أشبه الشعراء الكلاسيكيين / لأنني لا أعترف أن ميدان التحرير / سوف يصبح هادئا وقت الذروة". هناك علاقة وثيقة بين تفجير القصيدة وتفجر الواقع الذي لا يمكن أن يظل على هدوئه حين يبلغ وقت الذروة. وهذا ما نجده – كذلك – عند الشاعر حاتم حوَّاس حين يربط بين القصيدة وظواهر الفقر التي يعيش فيها، كما يبدو في قوله: "القصيدة التي تسكن / في بيتي المهدوم / تغرق في عبث البحث عن وطن / جائعة تضرب الأبواب"، وفي قصيدة "ياسيدي" يستمر في تأكيد هذا المعنى حين يقول متسائلا: "كيف تدخلنا القصائد / والعطن فوق أعطاف الطريق / ينسج ريحه الصفراء / ويعطي النهر إذنا بالدخول".
التناص وتيمات أخرى
يلعب التناص دورا واضحا في شعر نادي حافظ، ومن ذلك – على سبيل المثال- قوله في قصيدة "أصحو من نومي بلا قدمين":"اسمعوني قليلا / قبل أن يبدأ العصف / ماذا تظنون أني فاعل بدمي؟ من دخله آمن / ومن شربه أو اتخذه غيمة في أول المحو / من فرَشه سجادة للملوك آمن". وهو ما يذكرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش بعد فتح مكة: "ماذا تظنون أني فاعل بكم؟"، وقوله: "من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن". أما قول الشاعر: "رأسك نافورة للظنون / ورجلك دبابة ظالمة / والنمل لم يدخل مساكنه"، فهو يتناص – عكسا- مع قوله تعالى: "قلنا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم".أما قوله في قصيدة "خذوا أوطانكم عني":"خذوا أوطانكم عني / كلوني لهمي / لأفكاري الطائشة"، فيتناص مع قول النابغة:"كليني لهم يا أميمة ناصب / وليل أقاسيه بطيء الكواكب"، أو تساؤله عن يديه و"كيف تخرج بيضاء/ من غير معجزات / من قميص ناريمان" الذي يتناص مع قوله تعالى لموسى عليه السلام: "واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء"، وقوله – وهو عنوان إحدى القصائد – "نغدو خماصا ونعود أيضا خماصا"، يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطير التي تغدو خماصا أي جائعة، وتعود بطانا أي ممتلئة بالطعام ، المفارقة أننا نغدو ونعود كما غدونا "خماصا". وفي ديوان "مدن الموت المعلق" للشاعر حاتم حواس نجد ما يمكن أن نسميه "المحاكاة الأسلوبية"،وهو نوع من التناص الأسلوبي كما يبدو في قوله: "أحل لكم لحم الميتة والنطيح / وبقايا مما أكل الكلب / وأحل لكم المانجو / وحرمت عليكم الطماطم والذبيح". وواضح درجة التناص مع الأسلوب القرآني، وأحيانا يعون هذا التناص بالاستدعاء مثل قوله: "هل تعرف أن اللات والعزى على مفارق قريتنا / مازالا منصوبين / والنساء العابرات ذوات الخمار / يظهرن نهودهن / متباركات بالرب الذي لن يأتي الليلة". وفي ديوان "أزقة تشتهي قطعة سكر"، للشاعر صبري رضوان نلاحظ تطور غرض الرثاء حيث يبتعد عن البكائيات والأحزان والآلام، وذلك حين يرثي شاعر العامية محمد عبد المعطي بقوله: "هناك / استقبلوه بحفاوة شديدة / بدلوا التراب برمل ناصع / واللحد ببذلة مطرزة / وأوقدوا المصابيح كرمان طازج / تدلى من غصونه". لقد تحول معنى الموت وربما أصبح مشتهى، ويرجع ذلك إلى الإحساس الفادح بوطأة الحياة وثقلها وهو ما يعبر عنه الشاعر شحاتة إبراهيم في ديوانه "ليس فانتازيا أكثر مما ينبغي". حين يعبر عن اشتهائه للموت في قوله: "لا أظن أن قلبي سيتوقف فجأة / ولكن في لحظة معينة / سآمره بالكف عن التآمر ضدي / وسأسعى بكل ما أملك / إلى إسكات نبضه الذي يزعجني طوال الوقت / ويضطرني إلى الانتساب للحياة". ثم يعبر بوضوح – في قصيدة "إشارة محددة" عن كراهيته للحياة حين يقول: "أكرهك أيتها الحياة / أحبك حتى الجنون أيها الموت"؛ وذلك لأنه يعاني الفقر والتشرد ولا يملك سوى بعض الشعر والأغنيات.
الذات والعالم
واللافت أن الموت نفسه لايأبه لرغبته ولا يعطيه سوى إشارة واحدة هي أن يندمج في الحياة باحثا عن امرأة يحبها أو قصيدة يكتبها. ومن هنا تصبح علاقة الذات والعالم علاقة عدائية وذلك ما يبدو في قوله في قصيدة "اختلاف مشروع": "حيرتني علاقتي بالوطن / وكلما طرقت أبوابه / تهرب – كمُرابٍ حقير- من مواجهتي / ومن تسديد ماعليه من فواتير". بل إن هذه العلاقة غير السوية تنسحب على علاقة الشاعر بالمرأة؛ "التي افتقدت الحنان منذ صغرها تصر على العناد المبرمج / والرجل الذي فاته الدفء حريص على كل أنواع الخيانات". هذه العلاقة جعلتهم على قناعة بأن العذاب هو قدرٌ أكثر منه أي شيء آخر، "وأن الله خلقهم فقط ليختبروا قدرتهم على الحرمان". هذا الحرمان الذي يبلغ أقصى درجاته حين يعجز الشاعر عن استبدال حذائه، فهذه الشوارع التي تستقبله يوميا بحفاوة كبيرة لم تؤذ أقدامه أبدا، ولم تفسد حذاءه الوحيد؛ "الذي لم يتغير منذ سنوات طوال / دون أن يبدو عليه الوهن". وتبدو شجاعة الشاعر في كشف الزيف ومحاربته مزعجة لرجال الدين سواء كانوا شيوخا أو رهبانا؛ "سيرجمني شيخي بكل تأكيد / على تخبطي وتجديفي / وسيرجمني راهب الكنيسة على مغازلتي الدائمة للنساء في حضرته". وإذا كان شحاتة إبراهيم قد توقف عند الشوارع وأرصفتها، فإن صبري رضوان يتوقف عند الأزقة، كما يبدو في قوله: "سوف يحاسبني اللصوص / حسابا قاسيا / على كلامي الجارح / في مقالاتي عن الحرية / وتقاليدي التي اكتسبتها / من الشوارع الضيقة / والأزقة التي تطحن الحروف / لتشبع صغارها قبل النوم / وتشتهي قطعة سكر / أو رصيفا يناسب أقدامهم المتورمة". وتذكرنا هذه الأزقة – وهي مجاز مرسل دال على قاطنيها – التي تطحن الحروف لتشبع صغارها قبل النوم بالمرأة الفقيرة – في زمن عمر بن الخطاب - التي كانت تلهي صغارها بإشعال النار على الحجارة حتى يناموا. وهذا البعد الاجتماعي من التيمات المتداولة في هذا الديوان، حين يقول بوضوح: "لم يثر غضبنا / الأطفال الذين باتوا عراة / دون عشاء".
وفي ديوان "مدن الموت المعلق" للشاعر حاتم حواس تظهر الرؤية المأساوية للوجود حين يقول: "الصباح مازال يقطر دما / ويعتق الترياق لي / ليست كل المراكب تستطيع العبور في العاصفة". كما تظهر تيمة التحولات من حالة إلى أخرى؛ كأن تتحول السيارات العابرة إلى مراكب ذات مهارات خاصة. على أن هذه التيمة شديدة الوضوح عند نادي حافظ كما يبدو في هذا الشاهد: "قل لمن يلتقيك: رجل مسكون منذ زمن / مرة يتحول إلى حديقة / لأنه يشتاق إلى الأطفال / ومرة إلى باص لايجد المحشورون فيه النفس / ومرة قطة / ومرة جمل / قل لهم: ياناس اقبضوا عليه إن وجدتموه / قبل أن يتحول إلى قبر". بل إن الشجرة التي هي رمز للحياة والجمال تتحول على يد الإنسان إلى باب للسجن، كما يبدو في قوله: "ما ذنب هذه الشجرة / خلعوها من الجنة / وشرَّدوا طيورها ونصبوها بابا على السجن؟". كل هذا يؤكد درجة التحولات الكبيرة التي حققتها قصيدة النثر.
------------------------
بقلم: د. محمد السيد إسماعيل